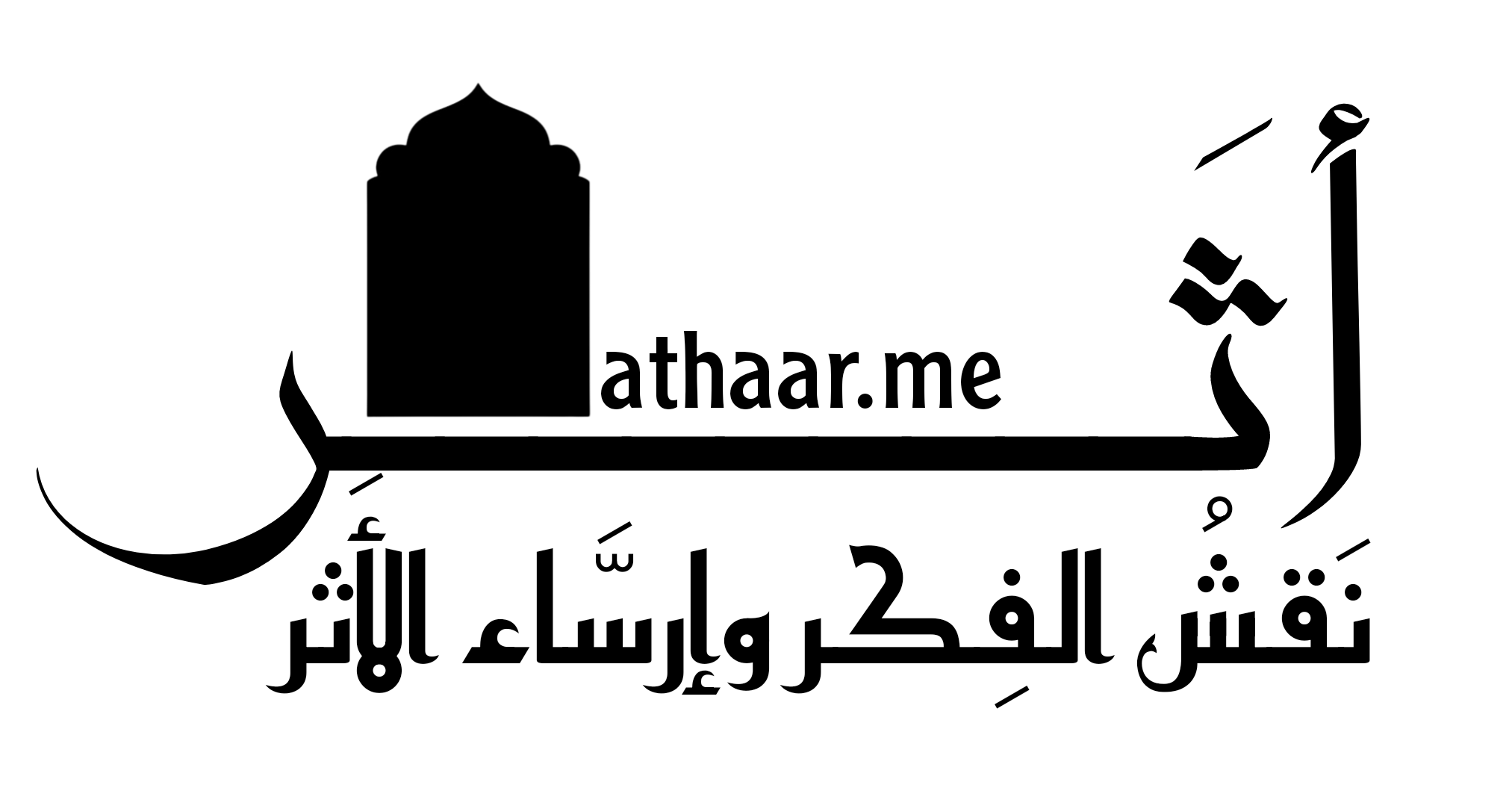بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علَّم بالقلم، علَّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلّم الناس الخير محمد، أما بعد: نستفتح هذا المقال بتحية “فتى الكهول”، كما اشتهر بها المهندس عبد الرحيم – فكّ الله أسره وأعاده سالمًا – الذي ترك في نفوس كثيرٍ منّا آثارًا حميدة، وعلَّمنا من فضل الله ما علّمه إيّاه سبحانه. وكواجبٍ علينا تجاهه، وتجاه من لم يستقِ منه، أعددتُ هذا المقال لتجميع وتلخيص إحدى أهم المحاضرات التي ألقاها المهندس أيمن، والتي تحمل ذات اسم المقالة، وكان لها أثر بالغ في نفوس الكثيرين، إذ ساعدت على التعلّم ومهّدت الطريق نحو سبلٍ سليمةٍ لاكتساب المعرفة قريبة الى مراد الوحي.
سيكون هذا المقال شاملًا لأغلب ما طرحه المهندس أيمن في محاضراته الثلاث، بأسلوبٍ أقرب إلى التلخيص والتقريب. ومع ذلك، فإن طوله أمرٌ لا مفرّ منه. كما أن هذه المقالة لا تُغني أبدًا عن متابعة السلسلة والاستفادة منها، بل إن أقصى استفادة منها تكون لمن تابعوا السلسلة.
رابط السلسلة المعنيّة: دورة كيف أتعلم؟ ماذا أتعلم؟ | م.أيمن عبد الرحيم
محتويات المقال
- 1 تحديات الأجيال المختلفة.
- 2 القسم الأول: كيف تتعلم وماذا تتعلم؟
- 3 القسم الثاني: ماذا قبل أن أبدأ في التعلُّم؟
- 4 القسم الثالث: نصائح عامة واستراتيجيات للتعلم
- 5 القسم الرابع: أسئلة في ذهن القارئ
- 6 ختام ثلاثية التعلم
تحديات الأجيال المختلفة.
لكل جيلٍ تحدياته التي تميّزه عن الأجيال السابقة؛ إذ يحمل كل جيلٍ ما ورثه من تحديات من سبقوه، ويضيف إليها تحدياتٍ جديدة تخصّ واقعه وزمانه. ولهذا، يستمر كل جيلٍ في طرح الأسئلة القديمة، إلى جانب تساؤلات جديدة.
ومن أبرز تحديات هذا الجيل المعاصر شيوع المعلومات وإتاحتها بشكل غير مسبوق؛ فقد بات توفّر المصادر ميزةً لهذا العصر، وأحد تحدياته في آنٍ واحد. ومن آثار هذا التوفر اشتداد اللبس الحاصل في التفريق بين الثقافة والعلم، فضلًا عن صعوبة البناء والتجديد في بنية العلم بسبب الفيضان المعلوماتي، وما يستتبعه من ضرورة استيعاب كمٍّ هائل من المعارف. كما نتج عن ذلك تفشي ظاهرة الجدل المعرفي السطحي، نتيجة الخلط بين القدرة على جمع أكبر قدر من المعلومات، والقدرة على اكتساب المعرفة الحقيقية.
وفي خضم هذه التحديات والظواهر، يلحّ سؤال كبير على هذا الجيل الصاعد: في وسط هذا السيل المعلوماتي والرقمي، ما الذي ينبغي عليَّ أن أتعلمه تحديدًا؟ وما المجال الذي يجب أن أتخصص فيه؟
ويبقى السؤال الأصعب: ماذا لو لم أعرف بعدُ ما الذي أريد أن أتعلمه؟ فكيف أكتشف ذلك؟ وماذا أفعل حتى يحين الوقت الذي أعرف فيه؟
وتسعى سلسلة المحاضرات إلى تقديم محاولة مستفيضة للإجابة على هذه الأسئلة، وقبل محاولة الإجابة على هذه الأسئلة، علينا طرح بعض النقاط في تصور منظور أكثر شمولية: تأثير القيم الحضارية على العلوم.
كل حضارة بشرية تمتلك قيمة مركزية.
لكل حضارة بشرية قيمة مركزية تُعد بمثابة العمود الفقري الذي تستند إليه مجالات الحياة كافة، من الفكر والدين إلى الفن والسياسة. فالحضارة الإسلامية، على سبيل المثال، وضعت التوحيد والإيمان بالله في قلب رؤيتها للوجود، وانعكس ذلك في فنونها، نظمها القانونية، وتعاملها مع الإنسان والكون. أما الحضارة الغربية الحديثة، فقد بنت نفسها على قيم العقلانية والفردية وحقوق الإنسان، وهي مبادئ توجه تفكيرها العلمي ونظمها الديمقراطية. هذه القيم ليست مجرد شعارات، بل هي القوة المحرّكة لتقدم كل أمة وازدهارها.
في الحضارة الصينية التقليدية، شكّلت مركزية الإمبراطور القيمة المحورية التي بنت حولها الدولة والمجتمع رؤيتهم للعالم. فالإمبراطور لم يكن فقط حاكماً سياسياً، بل كان يُعتبر “ابن السماء”، يمثل الرابط بين النظام الكوني والأرضي، ويجسد الانسجام بين القوى المتضادة. من هنا، تفرعت قيَم مثل الطاعة، والتراتبية، والاستقرار، التي استمرت حتى بعد تحولات سياسية كبرى. ومع دخول العصر الحديث، تراجعت مركزية الإمبراطور، لكن الأثر الثقافي لفكرة السلطة المركزية لا يزال واضحًا في بنية المجتمع والدولة.
القسم الأول: كيف تتعلم وماذا تتعلم؟
حسنا، دعنا نبدأ في الاجابة على سؤال: ماذا أتعلم وأتخصص؟ مقسمًا الإجابة الى مراحل مرتبة.
أولًا: التعرف على العلوم
اكتشاف أكبر قدر من العلوم والمعارف يكون من خلال القراءة والاطلاع في كتب “الكتب” أو “فهرس الفهارس”، وهي كتب تساعد على التعرف على مجالات وتخصصات العلوم المتاحة.
احالة: كتاب دليل القارئ إلى الثقافة الجادة
وهذه موسوعة تصدرها الولايات المتحدة من حينٍ لآخر، وقد ترجمتها الهيئة العامة المصرية للكتاب. تتيح هذه الموسوعة نظرة أفقية على العلوم وفروعها، وأهم الكتب في كل علم، وأبرز العلماء المؤثرين فيه. وتمتاز الموسوعة بكونها مفهرسة بالكامل.
احالات أخرى: سلسة كتب: أقدم لك و سلسلة: مقدمة قصيرة جداً
ثالثا: تناسب الغاية مع الإطار الشخصي والعالمي
وبعد الاطلاع العام على العلوم، ومعرفة مجالات ربما لم تكن تعلم بوجودها، يأتي دور الدراسة الأفقية للعلوم، وهي محطة تستحق الوقوف عندها.
الهدف من هذه الخطوة ليس تحقيق حصيلة علمية وافرة، بل — إن صحّ التعبير — تجربة تعلّم العلم على أرض الواقع، من خلال الاستفادة من أسسه في أقصر وقت ممكن عبر تكثيفه. بتعبير آخر، هي محاولة واقعية للإلمام بكمٍّ كبير من العلوم قبل التعمق فيها. وكما يقول المثل المصري الشهير: “خد فكرة واشتري بكرة”.
منحنى التعلّم ليس خطّيًا في العموم، حيث إن أكبر قفزة في عملية التعلّم تحدث خلال العشرين ساعة الأولى. ويُفضَّل في هذه الساعات تكثيف الجهد ليشمل الموضوعات العشر الأساسية في كل علم.
يمكن أن يتم تكثيف العلم أو تعلّم المهارة خلال هذه العشرين ساعة عبر كتاب أو محاضرة، مع تفضيل الكتب؛ إذ توجد العديد من الكتب المتخصصة في “تكثيف العلم”، مثل كتاب: ماجستير إدارة الأعمال في يوم واحد.
ويمكن الاستفادة أيضًا من الملخصات والكتيبات المصمّمة خصيصًا لغرض تكثيف علمٍ ما أو تعلّم مهارة معينة، مثل موقعَي Quick Study Guide وSparkChart.
وجديرٌ بالذكر هنا التحذير من ظاهرة “التشغيب” أو “الرطانة العلمية”، وهي الادّعاء والظهور بمظهر من ينتمي إلى هذا العلم دون أن يكون كذلك. إذ ينبغي مراعاة حدود ما تم تحصيله من الدراسة الأفقية، والتي لا تتيح إتقانًا أو إحاطةً شاملة بموضوعات العلم. فلا بأس من الحديث عما تعلمته من علوم ومعارف مع الآخرين من باب التحدث بنعمة الله ونشر الفائدة، لكن دون أي انتساب أو تظاهر يتجاوز قدر تحصيلك. كما رُوي عن عمر بن عبد العزيز – رحمه الله -: “رحم الله امرأً عرف قدره”.
ثالثًا: تحديد المجالات المتاحة
بعد فترةٍ من الدراسة لعددٍ من العلوم، قد يصادفك شعور بأنك وجدتَ ما تبحث عنه في بعض التخصصات، ووجدتَ نفسك ميّالًا إليها ومحبًا لتعلّمها. وفي هذه المرحلة، عندما تحدد بعض العلوم التي تشعر نحوها بحبٍ واهتمام، لكنك محتار في اختيار الأنسب منها من حيث استعدادك وقدراتك، وهل تمتلك المَلَكات العلمية المطلوبة أم لا — فقد تُفيدك الاختبارات النفسية واختبارات القدرات في تفضيل بعض العلوم على غيرها، وتحديد: أيّها أولى بالدراسة؟ أو أيّها تُقدّم على الآخر — إن كنت قادرًا على دراسة أكثر من علم دراسة متعمقة.
ومن المهم إدراك أن القدرة على دراسة علمٍ ما بكفاءة لا تعني بالضرورة أنك تحبّه. فقد يُجيد بعضهم دراسة الطب ويحصل على علامات عالية فيه، لكنه لا يحبه، بينما يجد شغفه في مجالٍ آخر تمامًا. لذا، من الضروري التفريق بين ما يمكنك إجادته فقط، وبين ما تحبه وتُبدع فيه.
رابعًا: البدء في الدراسة الفعلية
بعد التعرف على العلم المرغوب ودراسة تفاصيله، ما الذي يتبقى؟ ببساطة: الشروع في دراسته. وهنا يأتي دور موقع Opensyllabus.org، حيث يوفّر هذا الموقع المناهج العلمية لأغلب التخصصات في أهم جامعات العالم، مع إمكانية مقارنة المناهج بين الجامعات المختلفة ضمن التخصص الواحد.
العلم هو أسئلة بني آدم عبر العصور، سواء أُجيب عنها أم لم يُجب
القسم الثاني: ماذا قبل أن أبدأ في التعلُّم؟
كل ما سبق قد يستغرق منك شهورًا أو حتى سنوات، وهذا أمرٌ طبيعي، فعملية الاستكشاف تتطلب جهدًا وصبرًا. لكن خلال هذه الأشهر أو السنوات، ماذا ينبغي أن أفعل إلى أن يحين وقت معرفة وجهتي العلمية؟ هل أكتفي بالاستكشاف والاطلاع فقط كما ذكرنا؟
تعلُّم مهارات أساسية تُعزِّز التعلُّم
في الواقع، أنسب ما يمكن فعله خلال هذه المرحلة هو تعلُّم المهارات التي تُحسِّن من تعلُّم أي علم، وهي ما سنُسمِّيه هنا “المهارات الأساسية”، مثل: التفكير بكفاءة، والقراءة والكتابة بمهارة، وتذكُّر المعلومات عند الحاجة، والتلخيص، والكتابة العلمية، إلى جانب المهارات الإدارية واللغوية… وسنذكر أهمها فيما يلي:
المهارات اللغوية (تعلُّم اللغات)
يمكن القول إن اللغة هي بمثابة الذراع للعقل. فبقدر قدرتك على الأداء اللغوي بدقة، بقدر ما تستطيع التقاط المعاني الدقيقة في العلوم. وبقدر إتقانك للغتك الأم، بقدر ما تتمكن من إتقان اللغات الأجنبية. فكثيرون ممّن نراهم يتباهون بإجادتهم للغة الإنجليزية ويستخدمونها في حياتهم اليومية، لا يُحسنون أدنى قدرٍ من لغتهم العربية. وهؤلاء في الحقيقة ليسوا متقنين للإنجليزية بعمق، فلا يستطيعون التقاط المعاني الدقيقة بها، ولا يُمكنهم التفكير الإبداعي من خلالها.
وجدير بالذكر أن اللغة العربية (بالنسبة لنا كمسلمين) لا تُمثل مجرد لغة نشأنا في بيئة تتحدث بها، بل هي لغة الوحي، واللغة التي اختارها الله لحمل رسالته الأخيرة إلى العالمين. فلا يكتمل إيمان المرء إلا بعربيةٍ حسنة.
ولا يقتصر أثر اللغة على إدراك المعاني الدقيقة في العلوم، بل هناك ارتباطٌ وثيق بينها وبين بنية العلوم ذاتها، كما في العلاقة بين الرياضيات والعلوم اللغوية كالنحو والصرف. فكما أن الرياضيات انبثقت من المنطق، فإن الكثير من القواعد النحوية صيغت على نحوٍ منطقي.
كذلك، فإن زيادة معرفتك العامة باللغة التي تدرس بها العلم يُعزز من قدرتك على تحصيله. فإذا كان مجال دراستك أحد العلوم الشائع تدريسه باللغة الإنجليزية كالطب مثلًا، فقد يكون من المناسب حينها دراسة اللغة الإنجليزية بشكل جيد، وكذلك بعض أساسيات اللغة اللاتينية — نظرًا لأن كثيرًا من المصطلحات الطبية ذات جذور لاتينية، ثم الاطلاع على الأدب والفلسفة باللغة الإنجليزية. ولهذا، من المهم إدراك الترابطات اللغوية، ومعرفة العلوم المُكمِّلة لمجالك العلمي.
إذا تعلمت الـ 500 كلمة الأكثر شيوعًا للسوابق (Prefixes) واللواحق (Suffixes) في اليونانية واللاتينية، ستزيد حصيلتك اللغوية في الإنجليزية إلى الضعف على الأقل، حيث أن الإنجليزية لها جذور يونانية ولاتينية.
من الاحالات الجيدة في هذا الصدد:
- سلسلة Accents with Amy على اليوتيوب -أصبحت للمنتسبين باليوتيوب حصرًا-.
- كتاب التطبيق الصرفي لدراسة الصرف العربي للمبتدئين.
- كتاب العروض التعليمي لدراسة العروض والقافية.
- كتاب الدروس النحوية لدراسة النحو العربي دراسة أساسية.
- سلسلة أحكام التجويد للشيخ أيمن رشدي سويد.
- كتاب دروس البلاغة لدراسة البلاغة العربية دراسة أولية.
- أكاديمة MIG لتعليم اللغة الالمانية ( متوفرة حصرًا للمقيمين في مصر).
مهارة إدارة الوقت والحياة
إحدى مشكلاتنا تكمن في التعبير عن قضايا جوهرية بأسلوب غير جاد، كما يختلط علينا أحيانًا التمييز بين مفاهيم أساسية مثل الغرض، الهدف، والرؤية. دعنا نُفصّل قليلًا في كلٍّ منها.
الفرق بين الغاية، الهدف، والخطة
الغرض أو الغاية هو الأوسع نطاقًا، إذ يجب أن يعبّر عن أسمى مطلبٍ لك في الحياة، ويجيب عن أحد الأسئلة الوجودية الكبرى: ما المطلوب مني؟ وما الذي يجب أن أفعله في هذه الحياة؟ وهذا السؤال، بالنسبة لنا كمسلمين، إجابته أيسر من غيرنا؛ فغايتنا الكبرى هي الجنة، ونسعى لأن نعيش على ما يُرضي الله عز وجل. ومن هنا، نحاول أن نُدرك ما هو مراد الله في كلٍّ منّا؛ فالله سبحانه لم يخلقنا عبثًا، ولم يضعنا في زمنٍ ومكانٍ وظروفٍ معينة بقدراتٍ ونفسياتٍ مختلفة عبثًا. لكلٍّ منّا اختباره الخاص وميزانه المستقل يوم القيامة.
فالمطلوب من كل فرد هو أن يحاول إدراك مراد الله منه، لأن الحساب لا يكون فقط على ما فعلناه، بل على ما كان بإمكاننا فعله بناءً على ما أُوتينا من نِعَم. ومن المحاضرات المهمّة في هذا الجانب محاضرة للمهندس أيمن ومن المحاضرات المهمّة في هذا الجانب — وأنصح بها بشدة — محاضرة للمهندس أيمن بعنوان من هنا نبدأ، ومحاضرة الأسئلة الوجودية الكبرى. كما لا غنى عن موسوعة المسلم المعاصر في التوبة والترقي في مدارج الإيمان للدكتور منير البياتي.
بعد تحديد غرضك، يأتي دور تحديد أهدافك. والكثيرون يخلطون بين الغرض العام والأهداف الحياتية. وفي هذه المرحلة، قبل أن تُحدد مجالك العلمي أو المهني بدقة، من الواقعية أن تضع أهدافًا مرحلية قريبة (على مدى سنة إلى ثلاث سنوات )فهذا أيسر للعمل عليه وأكثر مرونة، بخلاف الأهداف بعيدة المدى التي قد تتغير مع تغيّر معاييرك أو مجال دراستك. (وسنتحدث لاحقًا عن ما يجب فعله إذا بدأت دراسة تخصّصٍ ما، ثم اكتشفت لاحقًا مجالًا أنسب لم يكن في حسبانك: هل تتراجع أم تُكمل؟).
أهمية تحديد أهداف قصيرة ومتوسطة المدى
بعد تحديد غرضك وأهدافك المرحلية، تأتي الرؤية أو الخطة التي تركب عليها عملية التعلُّم. فإذا لم تحدد مهام يومية واضحة تنتهي منها، وأهداف أسبوعية محددة، فأنت لا تملك خطةً حقيقية، بل مجرد رغبة أو هدف عام. وتُعدّ مهارة تفتيت أو تجزئة المهام من أبرز مهارات إدارة الحياة. وكما يُقال: “كيف تأكل حوتًا؟ ببساطة: ملعقة بملعقة، وستنتهي منه مع الوقت.”
بعض الإحالات المساعدة على استيعاب مهارات إدارة الحياة:
- كتاب إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة – ينصح بالبدء به قبل البقية لعِظم فائدته-
- دورة على linkedin learning بعنوان: Time Management Fundamentals
مواجهة الكسل وضعف الهمة
من مهارات إدارة الحياة القدرة على التعامل مع ضعف الهمة والكسل والمماطلة. فالكثيرون عندما أدركوا أنه عليهم القيام بالكثير من الأمور -كما هو واضح حتى الآن في المقال- بدأوا يشعرون بأن الجبال حملت عليهم وكتفهم حُمل بالكثير من الأعباء حتى فقط للوصول إلى ماذا يريدون أن يتعلموا. فما بالك بقدر الجد والعمل عندما يبدأون بدراسة ما اختاروه. وهذا العبء إذا لم تكن خضته من قبل، فعقلك تلقائيًا سيتجنب الخوض فيه أو الإكمال “بجدية” تجنبًا للألم. ومن الجيد أن الكثير من هذه الأعراض يمكن قياسها والحد من تأثيرها عن طريق إزالة المزاج من المعادلة والالتزام المجرد في فعل المهام حتى ولو لن تقوم المهمة بكفاءة. فالغاية هنا هي تثبيت العادة وتنمية المسؤولية النفسية لديك.
من الإحالات المفيدة في هذا:
- موسوعة صلاح الأمة في علو الهمة (مفيدة جدا في تقوية الجانب المعنوي)
مهارة الإدارة المالية (الماليات)
ذات مرة، سأل شخصٌ ثلاثة من الأثرياء في ندوة عن طريقهم نحو الثراء، فكانت إجاباتهم على النحو التالي:
الأول قال: قال الأول: “لا تفعل شيئًا لا تحبه، وإن كنت تفعل شيئًا لا تحبه حاليًا، فتخلّص منه بالتدريج.”
قال الثاني: “لا تكتفِ بفعل ما تحب، بل تعلم كيف تجني المال من خلاله، وإلا ستتوقف عن فعله لاحقًا.”
قال الثالث: “معادلة الثراء هي: الربح الصافي = الأرباح – المصروفات. لكن إياك أن تُفكر في تقليل مصروفاتك فقط لزيادة صافي الربح، بل فكّر في ابتكار طرق لزيادة أرباحك.”
من هذه القصة ندرك أننا بحاجة إلى التوازن بين ما نحب وبين القدرة على تحقيق دخلٍ من خلاله، حتى نتمكن من الاستمرار في الحياة، والاستمرار في ممارسة ما نحب. وهذه المعادلة صعبة، خاصة إذا كان ما نحب خارجًا عن إطار المألوف، أو ضعيف الدخل في بيئتنا. لكن تكديس المهارات والمعارف قد يُسهم في تخفيف حدّة هذه المعادلة، خصوصًا في هذا العصر الذي يتّجه نحو الأنظمة اللامركزية، ويشهد توسعًا في فرص العمل الحر (Freelance)، مما يزيد من فرصك في إيجاد معادلة متوازنة.
أهمية الاستثمار في التعلُّم والمعرفة المالية
من أبرز المثبطات في الإدارة المالية اليوم هو التفكير “الموظفاتي”، حيث لا يزال البعض يتعامل مع الحاضر بأدوات الجيل السابق، متأثرين بنجاحات آبائهم الذين أنجزوا الكثير في ظل إمكانيات زمانهم. لكن السؤال الحقيقي: هل كانت الأدوات نفسها؟
بالتأكيد لا، فما أنجزه الآباء في عمرٍ كامل، يمكن إنجازه اليوم في سنوات قليلة لاختلاف الأدوات.
ومن هنا، يُعدّ الاستثمار في التعلُّم (خاصة في اللغات) من أعظم الاستثمارات الممكنة، لا سيما مع التوجه العالمي المتزايد نحو الصناعات المعرفية.
من أفضل الاحالات الكتاب الشهير: الأب الغني والأب الفقير لروبرت كيوساكي و كتاب الثقافة المالية للطفل
ملاحظة هامشية
ذكر المهندس في المحاضرة كتاب أخر بعنوان: تعليم الأمور المالية للأطفال لنفس المؤلف، لكن بعد بحثي لم أجد كتاب كهذا.
فقمت باضافة هذا الكتاب الاخير جهد شخصي مني، فهو احالة مني وليس من المهندس أيمن.
مهارات الإدارة
تربّينا منذ الصغر على التفرّق والانفراد لا على التعاون والعمل الجماعي، فأصبحنا — حين نجتمع — نزيد ضعفًا بدلًا من أن نكون قوة. ويعود ذلك إلى ضعفٍ عام في مهارات الإدارة بمجتمعاتنا، وقلة الممارسة الفعلية للإدارة والتأثير داخل المجتمع، إضافةً إلى عوامل سياسية ليس هذا موضع نقاشها.
ويُنصح بتعلُّم أساسيات الإدارة، ولو بشكل أفقي في البداية، وهناك العديد من الإحالات المفيدة لذلك:
كتاب: ماجستير إدارة الأعمال في يوم واحد.
كتاب ماجستير إدارة الأعمال في عشرة أيام
بعض المهارات العامة
ارفق هنا بعض الحالات حيال الكثير من المهارات العامة والمتنوعة الذي من المهم جدًا الاستفادة منها على نحو خاص:
علوم الحاسب:
منحة وزارة الاتصالات المصرية (متوفر حصرًا للمتخريجين بالجامعات المصرية)
مُقدمة فى علوم الحاسب من جامعة هارفارد
أكاديمية AGC لتعليم هندسة صناعة البرمجيات
مهارات الملاحظات والتلخيص:
مهارات الدراسة:
كتاب تسريع القراءة وتنمية الاستيعاب
كتاب القراءة السريعة لتومي بوزان
أكاديمة الطباعة لتعليم الكتابة السريعة.
دورة على كورسيرا : Learn how to learn
موقع مهاراتي
موقع القراءة السريعة
بعض الاحالات في البدء بدراسة العلوم الشرعية.
بعض الاحالات لزيادة تحصيل الثقافة العامة.
القسم الثالث: نصائح عامة واستراتيجيات للتعلم

حاول أن تتعلّم أكثر من علم في الوقت نفسه، وذلك لاعتبارات تعود إلى قانون الاقتصاد في التعلُّم، ولتجنّب الوقوع في وهم التخصّص المُبكِّر، حيث قد تتوهم أنك وجدت مجالك وتغوص فيه أكثر من اللازم، ثم تتوقف عند نقطة معينة دون انتقال. فانتبه ألّا تقف في منتصف الطريق، وحاول بكل طاقتك الاستمرار في عملية التعلُّم، لأن الاستمرار يمنع من تثبيط الهمة، ويُخفّف من الإحساس بطول المسار.
صاحب الفن الواحد يجهل كثيرًا من فنّه، فعامّةُ مسائله مدسوسة في غير مظانّها.
هناك تطبيقات على الهواتف تساعدك على تتبع عدد ساعات دراستك، سواء عبر الكتب أو المحاضرات أو غيرها. كان المهندس أيمن قد نصح بتطبيق معين، لكنه لم يعد متاحًا، وبناءً على تجربتي الشخصية، أنصح بتطبيق Boosted لأجهزة الأندوريد.
موقع Coursera من المنصات المفيدة جدًا لتعلُّم دورات متنوعة، لكنه قد يكون مكلفًا أحيانًا. ويمكنك استخدام ميزة Financial Aid (الدعم المالي) للحصول على الدورات مجانًا أو بسعر مخفّض. وهناك طريقة محددة لتعبئة طلب الدعم بنجاح، يمكنك العثور عليها عبر هذا الرابط.
الثقافة تشبه النظارة التي ترى بها العالم؛ فحتى لو لم تُمارس بعض العلوم التي تعلّمتها، يمكنك أن تُرشد بها غيرك، أو تغرسها في ابنك منذ صغره، كما فعل والد الإمام البخاري حيث كان تاجرًا محبًا للعلم، فغرس حب العلم في ابنه، حتى أصبح ما أصبح. فإن لم تنجُ أنت، فحاول أن تُنجي غيرك، فتنال بذلك النجاة. وربّ مبلغٍ أوعى من سامع.
القسم الرابع: أسئلة في ذهن القارئ

جمعت بعض الأسئلة الذي طرحت على المهندس ايمن أثناء المحاضرة من الجمهور، نقلتها بتصوف.
س: إذا كنت حاليًا أمتلك وظيفة لا أحبها، هل أخاطر في الانتقال إلى العمل الحر للتفرغ أكثر في تعلم علوم ومجالات أحبها؟
ج: اكتساب المهارات الأساسية العامة والبدء بالانتقال التدريجي إلى مجال جديد (Career shift) خير لك من الإقدام على مخاطرة ومغامرة غير محسوبة تمامًا.
س: هل عليَّ البدء في العمل الحر منذ البداية إذا كان باستطاعتي ذلك؟
ج: هذا السؤال تنقسم إجابته إلى قسمين:
القسم الأول هو أن كل إنسان مختلف عن الآخر، فالبعض قد تكون الوظيفة ملائمة له أكثر من العمل الحر، ويمكنه التوفيق بينها وبين ما يتعلمه وحياته عمومًا. لذا، من المستحسن أن تجرب كلا الأمرين: العمل الوظيفي والعمل الحر، حتى تقرر ما الأفضل لك.
القسم الثاني هو أنه حتى لو كنت مدركًا سلفًا بأن العمل الحر هو الأنسب لك، فمن الأفضل أن تقوم بتجربة العمل الوظيفي أيضًا من باب التعرف على الشيء يزيد التعرف على نقيضه. حاول أن تكون التجربة في حدود 6 أشهر، ستتعلم من هذه التجربة بلا شك.
س: بدأتُ بالفعل في تخصّص علمي، لكني اكتشفت مجالًا آخر أنسب لي، فهل أكمل أم أنتقل؟
ج: إن كنت تدرس المجال أكاديميًا في جامعة، فمن الأفضل أن تُكمل وتحصل على شهادة، ثم تنتقل إلى المجال الجديد. أما إن كانت دراستك ذاتية أو غير أكاديمية، فابدأ بالانتقال التدريجي.
شبه المهندس أيمن هذا بمن دخل مبنًى مكوّنًا من 12 طابقًا يبحث عن شيء، وعندما وصل للطابق الثامن أدرك أنه في المبنى الخطأ، وأن الصحيح بجواره. هل يكمل أم يبدأ من جديد؟ الأفضل أن يُكمل حتى الطابق الأخير ليتأكد، ثم ينتقل للمبنى الصحيح من الأعلى — لا من الصفر. أي: ابحث عن المشترك بين المجالين، ولا تبدأ من جديد تمامًا.
س: أدرس مجالًا تخصصيًا كـ”الطب” مثلًا، ولا أشعر بالارتياح فيه، وفي الوقت نفسه لم أجد بعد ما أحب. هل أتركه؟
ج: أكمل ما بدأتَ فيه، فهو الأصل حتى يثبت العكس. وفي الوقت نفسه، استمر في الاطلاع على علوم أخرى بالتوازي.
س: هل من الطبيعي أن يستغرق تعلُّم المهارات الأساسية عدة شهور؟
ج: نعم، من الطبيعي أن يستغرق الأمر من 3 إلى 6 شهور، وقد يمتد لعام كامل حسب حصيلتك السابقة وكفاءتك. لا تستعجل، فتعلم هذه المهارات الأساسية والاطلاع الأفقي مهم جدًا لتسهيل الانتقال بين العلوم لاحقًا.
س: لماذا لا أستطيع الموازنة بين بعض الأعمال والعلوم؟
لأن ليس كل المهام تصلح للتوازي، ولا مع كل الأشخاص. فبعضها يُناسب التوازي، وبعضها التوالي، وبعضها لا يجتمع أصلًا. ابدأ بثبيت أحدها، ثم قيّم استهلاكه للوقت والطاقة، وقرّر بعد ذلك. إذا كانت المجالات متقاربة أو تخدم بعضها، فسيكون من الأسهل الجمع بينها. مثلًا: الفقه، التاريخ، والكتابة الإبداعية يمكن لبعض الأشخاص دراستها معًا بسهولة.
وضرب المهندس أيمن مثالًا في هذا: أن أسطوانات المدمجة (CD) مساحتها لا تكفي إلا لحمل نسخة ويندوز واحدة. لكن قد تجد البعض يمكنه وضع نسختين مختلفتين على أسطوانة واحدة. فكيف؟ عن طريق وضع الملفات المشتركة في النسختين في ملف واحد مشترك بينهما، ووضع الملفات المختلفة بينهما على حدة. فلم يعد بحاجة إلى تكرار ذات الملفات المشتركة في كل منهما في الأسطوانة. فاستغلال وجود ملفات مشتركة في كليهما -لأنهما نسختا ويندوز لكن الإصدار مختلف- ساعد على وضع نسختين في مساحة أقل.
ختام ثلاثية التعلم
وفي الختام، وقتنا محدود على هذا الكوكب، ولابد أن نُحسن استثماره، فنقتصد في الأفعال، ونوفّر الجهد قدر الإمكان، حتى نتمكن من حمل ولو قليلٍ من رسالة الإسلام في هذا العصر المضمحل، ورفعة شأنها بين الأمم.وأرجو أن ينفعنا الله بما علّمنا وتعلّمنا، وأن ينفعنا بالمهندس أيمن عبد الرحيم.
وأختم كما بدأت، بأحد أشهر ما اشتهر به فتى الكهول: (سقف الممكن مذهل).
سبحانك وبحمدك لا اله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
المرء بين قيمته فيما يُحسن وبين قيمته فيما يطلب