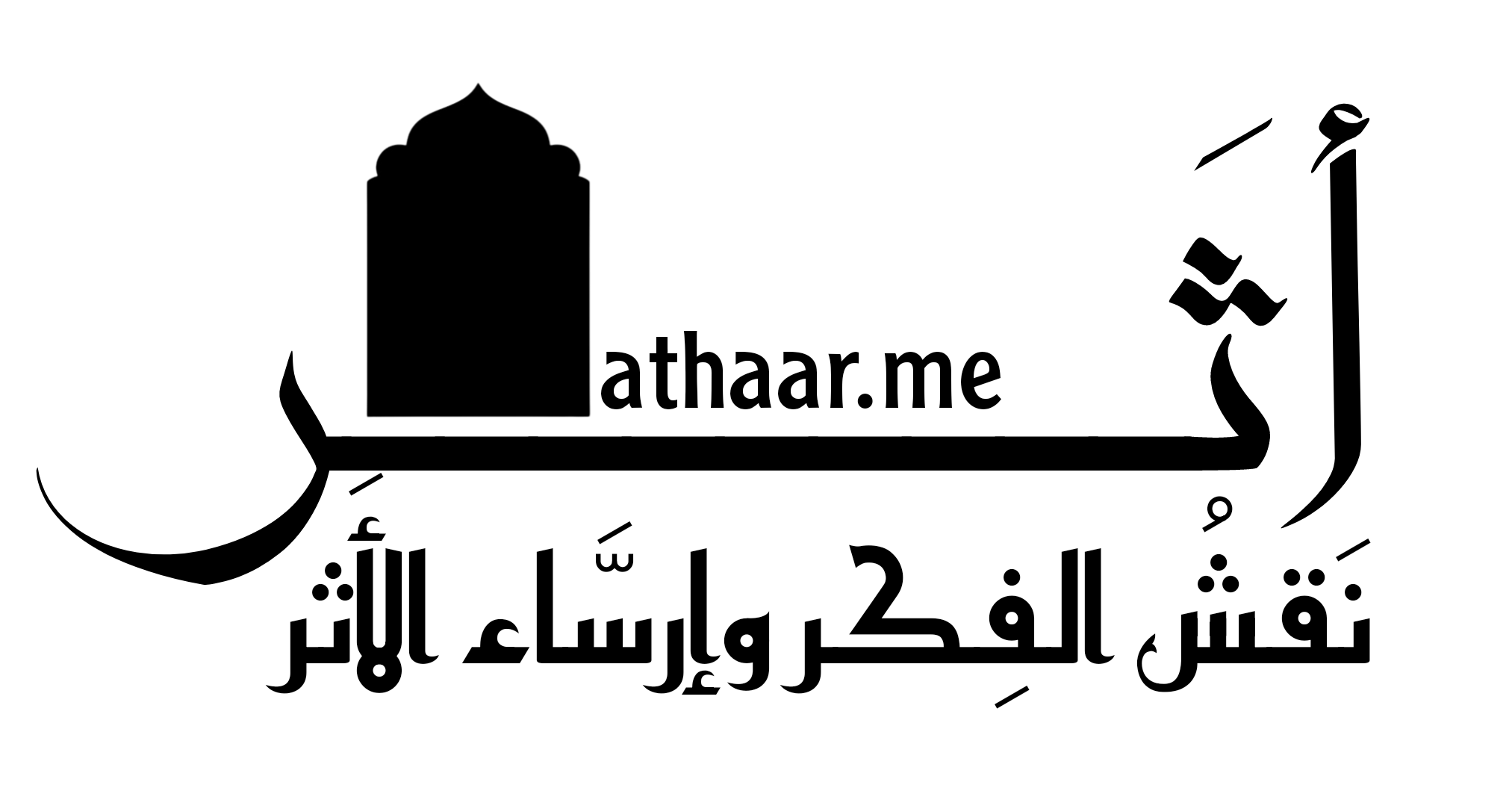نستعرض في هذا المقال نشأة العولمة وأصولها، وما تحديات المسلمين في ظل هيمنة العولمة، وما التأثيرات الناتجة عن الإنغماس فيها؟ وما سبل الانفلات منها ولو جزئيًا.
محتويات المقال
نشأة العولمة
منذ نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي، أصبح العالم ذا هيمنة أحادية تمثّلت في سيطرة المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ تلك اللحظة، بدأ العالم يتأثر بقرارات أمريكا، سواء تلك الصادرة عن البيت الأبيض، أو عن مؤسسات غير حكومية، خاصة في ما يتعلّق بالقرارات التجارية والسعي لجعل التجارة بين دول العالم أكثر سهولة وانسيابية. حتى بات استيراد المواد الخام أو المنتجات من دولة مجاورة أقل تكلفة من توطين صناعتها محليًا، وهو أمر شائع بين دول الاتحاد الأوروبي، نتيجة للأنظمة التجارية الموحّدة.
سعت الولايات المتحدة، في إطار مشروعها لضمان الهيمنة العالمية، إلى ربط مستقبل الدول اقتصاديًا بالمؤسسات والمشاريع الدولية التي تُدار في أغلبها تحت نفوذها المباشر أو غير المباشر. كما سعت إلى احتكار موقع القيادة في التجارة العالمية، من خلال سيطرتها على معظم المؤسسات التجارية الدولية الكبرى، وإدارتها من داخل أراضيها، ومن أبرز مظاهر هذه الهيمنة ربط الدولار الأمريكي بالتجارة العالمية، ليُصبح العملة التجارية الأهم والأكثر استخدامًا لعقود طويلة.
ومن أدوات هذه الهيمنة الاقتصادية والثقافية في آنٍ واحد هو الشركات متعددة الجنسيات، التي فتحت فروعها في مختلف أنحاء العالم، خصوصًا تلك التي تُنتج سلعًا استهلاكية يومية، فأصبحت علامات تجارية مثل “ماكدونالدز” و”كوكاكولا” وغيرهما جزءًا من الحياة اليومية لكثير من شعوب العالم، كما هي في الحياة الأمريكية، بل ويسعى الناس لاقتنائها ومحاكاتها. وهكذ، لم تكتفِ أمريكا بتصدير منتجاتها، بل وضعت نفسها (عبر تلك الشركات) في قلب حياة الشعوب الأخرى.
“والعولمة هي تصاعد معدلات الترشيد المادي على مستوى العالم، بحيث يصبح العالم كله مادة استعمالية، مجرد سوق ضخمة، ويصبح كل البشر كائنات وظيفية، أحادية البعد، يمكن التنبؤ بسلوكها وتوظيفها.”
وامتلاك الولايات المتحدة للنفوذ التجاري العالمي منحها سلطة هائلة على مصائر الدول اقتصاديًا، فأصبحت الدول التي تختلف معها أو تقع في توتر سياسي معها عرضة للعقوبات التجارية، وتُستخدم هذه العقوبات وسيلة للحد من قدرة هذه الدول على المتاجرة مع بقية العالم، أو لحرمانها من استخدام الدولار الأمريكي في معاملاتها، أو من خلال فرض قيود مصرفية داخل الأنظمة المالية العالمية. ويُلاحظ هذا بوضوح في حالة كلٍّ من روسيا وإيران في الوقت الراهن، لكن فرض أمريكا لنفوذها لم يقتصر على الجانب التجاري فقط، بل تعدّاه إلى الجانب القيمي والشكلي؛ إذ أصبحت سلوكيات المجتمع الأمريكي، وأفكاره، وثقافته، المزاج العالمي السائد. وذلك من خلال تصدير هذا النمط عبر صناعة السينما، خاصة أفلام هوليوود، التي كرّست في كثير من الأحيان صورة “البطل الأمريكي” الذي تُلقى على عاتقه مسؤولية إنقاذ العالم، أو حماية إحدى الدول، في ترويجٍ ضمنيّ لفكرة أن أمريكا هي حامية البشرية، والأدرى بتحديد من هم “الأشرار”.
كل ما سبق يشير إلى كيفيّة تصدير الهالة الأمريكية عالميًا منذ عقود وحتى اليوم، مما ساهم في نشوء مصطلحات ومفاهيم تدعو إلى “توحيد” البشر فنيًا وتجاريًا وسلوكيًا وثقافيًا تحت ذريعة تقليل الاختلاف، والفرقة، والكراهية بين الناس، فإذا أصبحنا متشابهين، فلمَ الكراهية أو العداء؟
ومن الواضح أن القيم التي أصبحت تُعتبر عالمية هي في حقيقتها انعكاس مباشر للمزاج الأمريكي: قيم استهلاكية، ترويج دائم للإعلانات، تركيز شديد على مركزية المال، وتقديم الفردية والذاتية على حساب الروابط الاجتماعية. وكل ذلك يعكس صورة نمطية للسلوك العام، تُقدَّم على أنها “الطبيعي”، لكنها في الواقع مجرّد نموذج واحد فُرض على العالم بوسائل ناعمة.
المسلمين في ظل العولمة
المسلمون في ظل عصر العولمة
يواجه المسلمون في هذا العصر تحديات عدّة في فهم العولمة والتعامل معها، سواء على الصعيد الفكري أو الحياتي، حيث يبدو كثير من المسلمين في حالة من الغفلة والتوهان، منغمسين في سلوكيات العولمة المختلفة. وتمثّل هذه الفئة الشريحة الأكبر؛ إذ لا غرابة أن تراهم يتّبعون الموضة الغربية في اللباس كارتداء الملابس الممزقة في مواضع معيّنة أو تصفيف الشعر بطرق منتشرة عالميًا، أو الانجراف وراء الشراء الاستهلاكي بلا حاجة حقيقية، فقط لأن “المزاج العام” يميل لذلك، كما في اللهاث خلف أحدث إصدارات الآيفون سنويًا.
وعلى الجهة المقابلة، نجد شريحة من المسلمين لم يقعوا فريسة للعولمة ومتطلباتها المادية والاستهلاكية، بل يحاولون التمسك بالقيم الإسلامية وسط بيئة عولمية جاذبة. وتكثُر هذه الفئة من المسلمين المحافظين بشكل ملحوظ في المجتمعات الغربية، حيث يسعون للحفاظ على ما يستطيعون من هويتهم، بالرغم من الضغط الثقافي والاجتماعي من حولهم.
الاسلام والعولمة: نقاط التشابك والإختلاف
فلسفة الاسلام والعولمة
تتمحور فلسفة العولمة، كما ذكرنا حول سعيها لتجميع البشر وتقريبهم إلى سلوكيات ونماذج حياة معيّنة ومحددة، بدعوى الحدّ من التفرقة والصراعات. لكن هذه السلوكيات، في حقيقتها، نابعة من ثقافة مجتمع بعينه، وتلك الثقافة منبثقة بدورها من أصول دينية ومعتقدات راسخة، حتى وإن ادّعى ذلك المجتمع العلمانية أو الليبرالية.
والعولمة في جوهرها إحدى منتجات الفكر العلماني، فهي فكرة يُروَّج لها عالميًا بحجّة إصلاح الإنسان وتحسين حياته، رغم أنها ليست حركة منظّمة لها جمعيات ومؤسسات، كما هو الحال في التيارات الفكرية الأخرى كالنسوية أو الليبرالية أو الديمقراطية.
بل تنتشر العولمة بأدوات ناعمة وغير مباشرة، تُشكّل مناخًا عامًا تزدهر فيه التيارات المنبثقة عن العلمانية، ولهذا فإن العولمة ليست تيارًا فكريًا مستقلًا بقدر ما هي الوسيلة التي يُنشر من خلالها الفكر الغربي وتياراته في المجتمعات الأخرى.
فإن قلنا إن التيارات والأفكار الغربية هي “الجنود” القادمون إلى بلادنا، فإن العولمة هي “القارب” الذي يحملهم إلينا.
وعلى الجهة المقابلة، تتميّز فلسفة الإسلام بأنها تقوم على إظهار التباين بين الحق والباطل، وبيان الفارق بين من يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، ومن لقي الحق ولم يُذعن له. فالاختلاف في التصور والرؤية الكونية واضح، بل هو مطلوب وضروري. إذ لا مجال للمماهاة أو التوفيق بين ما هو حق وما دونه؛ فلا يُمكن أن تتشابه القيم الحياتية، ولا الغاية من الوجود، ولا الإجابة على الأسئلة الكبرى بين المسلم وغيره.
فالمسلم يعيش على الأرض طالبًا رضوان الله وغفرانه، متعبدًا لله في ظاهره وباطنه، ويرى الدنيا دار ابتلاء واختبار. بينما غير المسلم قد لا يؤمن بوجود حياة بعد الموت أصلًا، أو يؤمن بها على نحو مختلف تمامًا وفقًا لمعتقداته. لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فالعولمة لم تُصِب شريحة كبيرة من المسلمين فقط، بل طالت أتباع الديانات الأخرى كالهندوس والنصارى واليهود؛ فكلٌّ منهم فقد شيئًا من جوهر معتقده، وتشوّهت غايته الوجودية أمام صنيعة العلمانية، وللمفارقة، تكاد لا توجد طائفة في العالم اليوم تُجابه العلمانية والعولمة والمُماهاة الحاصلة أكثر مما يفعل المسلمون الواعون بخطر التماهي مع هذه الأفكار.
من هنا، تتجلى نقاط التشابك والاختلاف بوضوح: فبينما تسعى العولمة لتذويب الفوارق الدينية والثقافية باسم “الإنسانية الواحدة”، يقرّ الإسلام بالاختلاف، ويُوجّه المسلم للثبات على هويته، مع السعي للتعايش مع الاخر بمراد الله، لا التماهي بلا وعي.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين البقرة: 213
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي (رحمه الله) هذا التفصيل في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، حيث طرح مسألة التشبّه بالكفار والمخالفين، ابتداءً من أبسط الأمور الحياتية، وانتهاءً بالاحتفال بأعيادهم، مستدلًّا بأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف. وقد بيّن وأكّد أن المشاركة بين المتشابهين في الهدي والظاهر أي في المظهر والسلوك لا بد أن تورث بينهما شعورًا بالتقارب، والتعاطف، والتوادّ.
إن المشاركة في الهدي الظاهر، تورث تناسبًا وتشاكلًا بين المتشابهين، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم- مثلًا- يجد في نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة- مثلًا- يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه متقاضيًا لذلك
بالإضافة إلى أن العولمة تتشارك مع الإسلام في متلقي الخطاب وعموميته لكافة البشر، إلا أن الإسلام يوجّه خطابه للناس بوصفه رسالة خاتمة من رب العالمين، مبشّرًا ونذيرًا، كما قال تعالى: (وما أرسلناك إلا كافةً للناس بشيرًا ونذيرًا) [سبأ: 28].
ولذا، فإن للإسلام رؤيته الخاصة في مفهوم “العالمية”، تختلف جذريًا عن رؤية العولمة. فالعالمية في المنظور الإسلامي تعني عودة الناس إلى فطرة التوحيد، وتحريرهم من كل صور الظلم والاضطهاد، سواء كان من أنظمة أو مؤسسات، عبر إبلاغ الرسالة الإلهية الخاتمة التي تهدي للتي هي أقوم.
وفي الرؤية الإسلامية، جميع البشر داخل إطار الأمة، وهم إما من “أمة الاستجابة” أو من “أمة الدعوة”، أي أنهم مخاطبون بالدعوة ومسؤولون عن تلقيها. لكن لا يمكن دعوة الآخرين بحق، ولا التأثير فيهم بصدق، ما لم يكن المسلمون مصداقًا لقوله تعالى: (كنتم خير أمة أُخرجت للناس).
العولمة: أداة استعمارية ناعمة
على الرغم من أن العولمة تبدو في ظاهرها انفتاحًا وتبادلًا، إلا أنها في باطنها تُجسّد شكلاً ناعمًا من الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية. فلم تعد الجيوش تُسيَّر، ولا البنادق تُشهَر، بل تُفتح الأسواق وتُفرض النماذج الغربية في أنماط التفكير، والاستهلاك، والحكم.
كأن الغالب لم يَعُد بحاجة إلى إراقة الدماء، يكفيه أن يغرس فيك شعورًا بالدونية، وأنك في حاجة دائمة إلى منتجاته، إلى أفلامه، إلى لغته، بل وإلى منظومته القيمية كاملة. ولهذا زمن الاستعمار لم يختفِ، بل غيّر أدواته، ليتماشى مع التطور التكنولوجي ووسائل الإعلام الحديثة، ويُعيد تشكيل وعي الجماهير، بإعادة تعريف مفاهيم مثل “النجاح”، و”الموضة”، و”القيمة”.
التلفاز والإنترنت، ووسائل الاتصال الجديدة، أصبحت أدوات فعّالة في هذا النوع من الغزو، وكان لهذا التأثير أن يبلغ مداه فقط لأن صناعته جاءت في زمن كانت فيه أمريكا تمثّل الدور المهيمِن والقوي عالميًا.
فبعد الحرب الباردة، وظهور أمريكا في موقع الغالب، ازداد ولع “المغلوبين” في تقليدها، مصداقًا لقول ابن خلدون: المغلوب مولعٌ أبدًا بتقليد الغالب.
والسّبب في ذلك أنّ النّفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه إمّا لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه أو لما تغالط به من أنّ انقيادها ليس لغلب طبيعيّ إنّما هو لكمال الغالب فإذا غالطت بذلك واتّصل لها اعتقادا فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبّهت به وذلك هو الاقتداء أو لما تراه والله أعلم من أنّ غلب الغالب لها ليس بعصبيّة ولا قوّة بأس وإنّما هو بما انتحلته من العوائد والمذاهب تغالط أيضا بذلك عن الغلب وهذا راجع للأوّل ولذلك ترى المغلوب يتشبّه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتّخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبّهين بهم دائما وما ذلك إلّا لاعتقادهم الكمال فيهم وانظر إلى كلّ قطر من الأقطار كيف يغلب على أهله زيّ الحامية وجند السّلطان في الأكثر لأنّهم الغالبون لهم حتّى أنّه إذا كانت أمّة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التّشبّه والاقتداء حظّ كبير كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة فإنّك تجدهم يتشبّهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حتّى في رسم التّماثيل في الجدران والمصانع والبيوت حتّى لقد يستشعر من ذلك النّاظر بعين الحكمة أنّه من علامات الاستيلاء والأمر للَّه.
الوعي أولى خطوات العلاج
من تحديات مواجهة العولمة أنها تغزو العقول أولًا، وتُضعف المناعة الفكرية والانتماء تحت شعار “التطوّر”، حتى صار من يُدافع عن قِيمه يُوصم بالتخلّف والرجعية، ويُمنع بذلك أي مجالٍ للمراجعة أو التفكير النقدي. كما أن وتيرة الحياة المعاصرة المتسارعة، والانغماس في التفاصيل اليومية، أثّرا سلبًا في قدرة الناس على رؤية الصورة الكبرى. فأصبح الواجب التعامل مع إخواننا أولاً في تفكيك خطاب العولمة قبل التعامل مع أصحابه الأصليين.
التمسّك بما أمر الله سبحانه، ورفض التبعية والانجرار وراء قيم وثقافات لا تُمثّلنا، لا يعني بالضرورة معاداة معرفة الآخر أو لغته وثقافته. فشتّان بين معرفة ثقافة الآخرين والانفتاح عليهم “تحت الإطار الفقهي”، وبين الانغماس في تلك الثقافات وتقديمها كأنها النهج الصحيح والسليم. إذ تتحوّل حينها من مجرد ثقافة محلية ضمن نطاق جغرافي محدد، إلى أداة يُهمَّش بها غيرها، وتُقاس من خلالها سلوكيات باقي الشعوب.
وعندما نشر المسلمون الأوائل الإسلام، انتشرت معهم الثقافة العربية في الأراضي المفتوحة، ومع ذلك لم تكن الثقافة العربية شرطًا أو متطلبًا على الشعوب الأخرى. فقد دخلت كثير من الأمم في الإسلام مع احتفاظها بقدرٍ مناسب (ومسموح به شرعًا) من ثقافتها، إلى جانب تعلّم ما يكفي من اللغة العربية لفهم الوحي في صورته الأولى. ولم يُروِّج العرب أو المسلمون الأوائل أن ثقافتهم هي الأنسب أو الأجدر، ولم يُجبِروا الناس عليها؛ إذ لم يكن المطلوب إلا تعلُّم العربية بالقدر الذي يُعين على فهم الدين، لا فرض الثقافة العربية في جوانبها الاجتماعية والحياتية.
ومن أفلح الوسائل في مجابهة هذا “الاستعمار الناعم” لعصر العولمة، هو العمل على الوعي الذاتي، والإطلاع الواعي على هذه الظاهرة المعاصرة، ونقل ما يُتعلَّم إلى الآخرين. ويُستحسن أن يكون ذلك مقرونًا بالتزود بالعلم، والاقتداء بهدي النبي في النصيحة والتعامل مع المخالف، مع البدء بالتغيير من النفس أولًا.
ونرشّح الإحالات التالية في هذا السياق:
1. العولمة: الجذور والآثار – د. عبد الوهاب المسيري
2. التغريب: أنماطه ومظاهره – د. جاسم سلطان
3. الإنسان المستلب: قراءة في فلسفة الاستهلاك – زهير دعيم
4. مستقبلنا بين التغريب والتغريب – مالك بن نبي
5. سلطة الثقافة الغالبة – إبراهيم سكران
خِتاماً
في السنوات الأخيرة، ومع تطوّر الأحداث السياسية والاقتصادية، بدأ يظهر على الساحة الدولية من يتحدّى الهيمنة الأمريكية، وعلى رأسهم الصين والهند. ورغم أن الفارق لا يزال كبيرًا، إلا أن المؤشرات تُشير إلى أن التنافس القطبي الدولي قد يعود من جديد، ومعه ستعود ثقافات شرقية أخرى لتحظى بنفوذ وهيمنة على بعض الدول الضعيفة، كما هو حال كثير من دولنا.
ولهذا، من الضروري أن نُدرك أن تغيّر الثقافة السائدة عالميًا لا يُغيّر من حقيقة تباينها الجوهري مع الحق الإلهي، ولا من ضرورة التمسّك بالهويّة الإسلامية. فالسعي نحو الظهور كـ”خير أمة” بين الأمم لا ينبغي أن يكون تبعيًا بين الأمم، بل نابعًا من يقينٍ برسالتنا، لنكون شهداء على الناس كما كان الرسول شهيدًا علينا ومازال.
“فالسؤال الحقيقي هو التالي: هل نطور الوحي ليتناسب مع الذوق المعاصر، أم نطور الذوق المعاصر ليرتقي إلى الوحي؟ … ومن يقول لك إننا يجب أن نطور أحكام الإسلام لتتناسب مع الذوق المعاصر، ففي مقولته هذه معنى ضمني … أنه يعتقد أن الذوق المعاصر أرقى من أحكام الوحي!”
“إن أخطر ما يعمل عليه الغرب في إطار استراتيجية هيمنته علىٰ العالم الإسلامي ليس تفوق القوة العسكرية، بل هو “القوة الناعمة” التي يتسلل بها من خلال “مناهج التعليم” و”الثقافة” و”الفن” وكُل مداخل الفكر التي يصل بها إلى تشكيل ذهنيات الأجيال المسلمة. نتائج هذه القوة الناعمة إن لم يتم التصدي لها كارثية. التصدي للقوة الناعمة الغربية يتطلب استراتيجية عالية التخطيط والإحاطة بأساليب الاختراق الغربي للمجتمعات المسلمة لتوفير دفاعات تتصدى لهذا الاختراق وتصنع مناعة داخلية عند الطفل والمرأة والرجل علىٰ حد سواء. وهذا يتطلب قادة أمناء أقوياء بإعداد عقدي وخلقي رفيع وتجربة وذكاء وشجاعة وتضحية”.